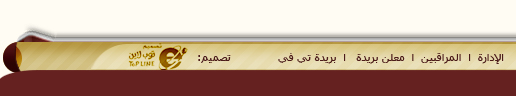هدايات الآيات:
1- {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}، (ما ودَّعك): ترجَّحت قراءة الجمهور بالتشديد من "ودَّعك" من التوديع؛ لأن وَدَع بمعنى: ترَك، فيها شدة وشُبْة جفوة وقطيعة، وهذا لا يليق بمقام المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عند ربه، أما الموادعة والوداع، فقد يكون مع المودة والصِّلة، كما يكون بين المُحبِّين عند الافتراق، فهو وإن وادَعه بجسمه، فإنه لم يُوادِعه بحبه وعطفه[2]، {وَمَا قَلَى}، ٍحذَف كافَ الخطاب؛ لثبوتها فيما معها، فدلَّت عليها، هكذا قال المفسرون، وقال بعضهم: تُركِت لرأس الآية، والذي يظهر من لطيف الخطاب ورقيق الإيناس ومداخل اللُّطف، أن الموادعة تُشعِر بالوفاء والود، فأُبرِزت فيها كاف الخطاب، أي: لم تتأتَّ موادعتك وأنت الحبيب، والمصطفى المُقرَّب"[3] .
أيها المؤمن، قد تَضيقُ عليك الدنيا، وربما يزدريك أهلُها، ويَحصُل لك من الشقاء والجفاء والعناء، ويَبرُز هذا المعنى في الذي نذَر نفسه لله داعيًا ولدينه مناصرًا، وعلى منهجه سائرًا، فهو يستشعر معيَّة الله معه، ونُصرته له، وخيريَّته فيما اختار الله له. وليعلم أن التمكين من لوازمه البلاء والضُّر، ولا يَسخَط ويتضرَّم ويشكو الله - عافانا الله - بل صَبْر وتفاؤل، {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}، تنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - لتكون له بلسمًا، وللدعاة والماضين على طريقته عزاءً، ولا شك أن الخَلْق برمَّتهم لو تركوك وقَلوك، لم يكن ذلك عندك شيء مع معيَّة الله لك، وتأييده الحق الذي معك، أفلا يعي أعيانُ الجيل هذا المعنى العظيمَ في طريقهم إلى الله، فلا يحزنوا ولا ييأسوا ولا يَنكُصوا ولا يَخذُلوا ولا يَرجُفوا ولا يَعسَروا ولا يَهِنوا ولا يحزنوا، بل تَجِدهم أوَّابين في شدة المِحَن، دعاة في شدة الفتن، متفائلين في شدة اليأس، مجاهدين في شدة البأس، البِشارة تعلو منطقَهم، والمدد من السماء يُصَب عليهم صبًّا؛ لأن الله معهم ولن يَتِرَهم أعمالَهم، "إنها بِشارة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن تَبِعه من العلماء والدعاة؛ أنه - سبحانه - لم يودِّع نبيَّه، كما يَزعُم المشركون، بل هو معه يؤيِّده ويَنصُره ويُثبِّته، وهو يحبه ولا يُبغِضه، بل يُدنيه إليه ويُعطيه، كيف يُبغِض مَن ينادي بالتوحيد، ويدعو إلى صراطه المستقيم، ويُقارِع الشركَ والظالمين؟! كيف يَقلي ويترك الربُّ الرحيم دُعاتِه وأنصارَه حتى تتخطَّفهم الشياطين، وهم ملتزمون بنهجه، مُكثِرون من ذِكْره، تَلهَج ألسنتُهم بالاستغفار والدعاء والترتيل لآيات القرآن؟ لم يودِّع الله أنبياءه ورسلَه ويَقليهم ويتركهم، فهذا نوح لما استنصره نصره، وقوم هود وصالح وشعيب ماذا فعل الله بهم؟ ولم يُودع الله إبراهيم - عليه السلام - لما ألقي في النار، ولم يودع يونس لما كان في بطن الحوت"[4].
2- {وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى}؛ أي: إن مستقبل حياتك خيرٌ لك من ماضيها، وإنك تزداد عزًّا ورِفعةً كل يوم، ولعاقبة أمرك خيرٌ من بدايته؛ وقيل: إن المعنى هو أن الدار الآخرة خيرٌ لك من هذه الدار الدنيا،. قال ابن سعدي: كل حالة مُتأخِّرة من أحوالك، فإن لها الفضل على الحالة السابقة[5]، قال ابن إسحاق: "الفرج في الدنيا، والثواب في الآخرة".
إن عادة البدايات تكون إرهاصًا للنهايات، والبدايات المُحرِقة تؤدي لنهايات مُشرِقة، قال شيخ الإسلام: "والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية، والأعمال بخواتيمها، والله تعالى خلَق الإنسان، وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا، ثم علَّمه فنقله من حال النقص إلى حال الكمال، فلا يجوز أن يُعتَبر قدْر الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال، بل الاعتبار بحال كماله"[6]، وهذا معنى عظيم ومفهوم عميق، قال ابن كثير: "والدار الآخرة خير لك من هذه الدار، ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزهد الناس في الدنيا، وأعظمهم لها إطراحًا، كما هو معلوم (بالضرورة) من سيرته. ولما خُيِّر - عليه السلام - في آخر عمره بين الخُلْد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، وبين الصيرورة إلى الله - عز وجل - اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية"[7]، ويتَّسِع هذا المعنى في الدارين في الدنيا والآخرة كما سبق بيانه، "فأما في الدنيا المدلول عليه بأفعل التفضيل، أي: لدَلالته على اشتراك الأمرين في الوصف، وزيادة أحدهما على الآخر، فقد أشار إليه في هذه السورة والتي بعدها، ففي هذه السورة قوله تعالى: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: 6 - 8]، فهي نِعَم يُعدِّدها تعالى عليه، وهي من أعظم خيرات الدنيا من صغره إلى شبابه وكِبَره، ثم اصطفائه بالرسالة، ثم حفْظه من الناس، ثم نصْره على الأعداء، وإظهار دينه وإعلاء كلمته، وأما خيرية الآخرة على الأولى، فعلى حدِّ قوله: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى: 5]، وليس بعد الرضا مَطلبٌ، وفي الجملة: فإن الأولى دار عَمَلٍ وتكليف وجِهاد، والآخرة دار جزاء وثواب وإكرام، فهي لا شكَّ أفضل من الأولى"[8]. فأنت تَمضي في حياتك مُستبسِلاً تروم حولك الدنيا وشهواتها والآخرة ومكارهها، فتتردَّد في الاختيار وتتجاذُبك الغرائز، فيستمِع قلبُك لنداء الإيمان {وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى} [الضحى: 4]، فلا تَقبل الدنيَّةَ في دينك، ولا تقبل الضيم في مبادئك، ولا تُقدِّم أحدًا على قيمك، ودائمًا ما يَعتَرِض شيء في بدايات الدعوات من ضيق وبلاء، فتروم النفسُ مباشرة لتصور الغاية الموعودة بها، فترضى وتستأنِف طاقتَها وقواها في بذْل الخير ودعْم الفضيلة، ونشْر الحق، قال سيد: "وإنه ليدَّخِر لك ما يُرضيك من التوفيق في دعوتك، وإزاحة العقبات من طريقك، وغَلَبة منهجك، وظهور حقك، وهي الأمور التي كانت تَشغَل باله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُواجِه العنادَ والتكذيب والأذى والكيد، والشماتة"[9]، نعم، لقد كانت الآخرة الدنيوية والأخروية خيرًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ففي الأولى بدأ حياةَ العناء والمشقة والظلم، ثم هاجر للمدينة فأقام دولة الإسلام فيها، وربَّى الجيلَ الأول، وخرَّج العظماءَ ليتسلَّموا قيادةَ الشرق والغرب، والأخروية فله من الكرامات العظيمة والمقامات الرفيعة والأعطيات الجزيلة يوم القيامة ما ليس يخفى ويُجهَل، ومن ذلك الخير الكثير في نهر الكوثر والشفاعة، وفتح باب الجنة.
3- المنة لله: قال تعالى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى * أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: 5 - 8]، هذا من بعض ما أعطى اللهُ النبيَّ، فيما مضى، ولسوف يُعطيه أكثرَ وأكثر فيما يَستقبِل من الحياة، فإذا نظر النبي إلى نفسه، من مولده إلى يومه هذا الذي لقيته فيه تلك الآيات - وجد أنه وُلِد يتيمًا، فكفَله الله، وأنزله من جده عبدالمطلب وعمه أبى طالب منزلةَ أعزِّ الأبناء وأحبهم إلى آبائهم، ثم إذا نظر مرة ثانية إلى شبابه، وجد أنه كان قَلِق النفس، مُنزعِج الضمير، مما كان يرى من الحياة الضالة التي يعيش فيها قومه، ولم يكن يدري كيف يجد لنفسه سكنًا، ولقلبه اطمئنانًا وسط هذا الجوِّ الخانق، فهداه الله إلى الخَلوة إلى نفسه في غار حراء، والابتعاد عن قومه، والانقطاع إلى ربه متحنِّثًا متعبدًا، متأملاً مُتفكِّرًا، وقد ظلَّ هذا شأنه إلى أن جاءه وحي السماء، فسكب السكينة في قلبه، والطمأنينة في نفسه، إنه - صلوات الله وسلامه عليه - كان يرى أن ما عليه قومه ليس مما يَدين به عاقل، أو تستقيم به حياة العقلاء، ولم يكن يَدري - صلوات الله وسلامه عليه - كيف يُغيِّر من مسيرتهم الضالة، ولا كيف يقيم هو نفسه هو على شريعة يُبشِّر بها في الناس، ثم إذا أعاد النبي النظرَ إلى نفسه مرة ثالثة، وجد أنه كان فقيرًا عائلاً؛ أي: كثير العيال، فأغناه الله، وسدَّ حاجةَ عياله، وغاية نعيم الدنيا هي الهداية ثم القناعة والزهد فيها؛ ففي الصحيحين - من طريق عبدالرزاق عن معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدَّثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه سلم -: ((ليس الغنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غنى النَّفْس)).
وفي صحيح مسلم، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قد أفلح مَن أسلم، ورُزِق كفافًا، وقنَّعه الله بما آتاه)).
وأقول: كم مَن شقيٍّ في الدنيا حرَم نفسه استشعار نِعَم الله عليه، أو جزَع من نزول الأقدار عليه - نسأل الله السلامةَ!
وهنا منهج رباني لكل من لمَس في نفسه اعتراضًا أو جزعًا، فليُعدِّد تلك النِّعم التي لا تُحصى، والهبات التي لا تُعَد، ثم يَنسِبها لربه، ويَشكُره ويَحمَده عليها، ولكنه الإنسان ظلوم جهول جزوع، يَفزع من الشر يُصيبه، وتُنسيه النِّعمُ شُكْرَ ربه؛ {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} [المعارج: 19 - 21]، والمصيبة العظمى عند مَن نزلت عليه الهِبات والعطايا والنِّعم فبات يَدَّعي فضلَها لنفسه، وينفي فضلَ الله عليه ورزقه له، فهذ قارون عصره، وكلامه هو الكفر بعينه: {إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي} [القصص: 78]، والصواب أن يكون الإنسان بين منزلة الشكر والحمد، شاكرًا في السراء، صابرًا في الضراء، ومَن شكَر فهو موعود بالزيادة {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7].
وأخيرًا، "تأمَّل قول الحقِّ ولم يقل: فآواك، فأغناك؛ لأنه لو قال ذلك لصار الخطاب خاصًّا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وليس الأمر كذلك، فإن الله آواه وآوى به، وهداه وهدى به، وأغناه وأغنى به"[10]، قال الله تعالى: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا} [الفتح: 20]، وما أكثر ما غَنِم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - حين اهتدوا بهديه، واتَّبَعوا سُنَّتَه فنصرهم الله تعالى به، وغَنِموا من مشارق الأرض ومغاربها، ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم، والغنى، والعزة، والقوة ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها يَنظُر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نُصْرة الإسلام أو خِذلانه"[11].
لطيفة: في الآية إشارة إلى أن الإيواء والهدى والغنى من الله؛ لإسنادها هنا لله تعالى.
ولكن في السياق لطيفة دقيقة، وهي مَعرِض التقرير، يأتي بكاف الخطاب: ألم يَجِدك يتيمًا، ألم يجدك ضالاًّ، ألم يجدك عائلاً، لتأكيد التقرير، ولم يُسنِد اليتمَ ولا الإضلال ولا الفقر لله، مع أنها كلها من الله، وفي تَعداد النِّعم: فآوى، فهدى، فأغنى، أسندها كلها إلى ضمير المُنعِم، ولم يُبرِز ضمير الخطاب، فلم يقل - سبحانه -: ألم نيِّتِمك ونأويك ونُضلك ونهديك ونعولك ونغنيك! ويظهر - والله تعالى أعلم -: أنه لم يُسنِد البلاء له - سبحانه - وذلك لما قد يكون فيه من إيلامٍ للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأما في تَعداد النِّعم أسندها لضمير المنعِم، ولم تكن لضمير المخاطب المباشر لما كان فيه من امتنان، وكونها نِعَم مادية، فلم يُبرِز الضمير لئلا يُثقِل عليه المِنَّة، بينما أبرزها في سورة الشرح: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 1 - 4]؛ لأنها نِعَم معنويَّة، انفرد بها - صلى الله عليه وسلم - والله تعالى أعلم[12].
4- {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} [الضحى: 9]: خصَّص الله هذا العنصر المهم من المجتمع في أكثر من آية، ولا سيما هذه الآية العظيمة المعنى العميقة الدَّلالة، هذا اليتيم الذي افتقد إما ذلكم الأب الذي يقوم على حاجاته ويتفهَّم ضروراتِه، ويدافع عن حقوقه، أو تلكم الأم التي تُغذِّيه بالحنان، وتُدفئه بالعاطفة، وتُظِلُّه بالعناية الوارفة، تعلو كلماتها الرحمة، وينساب من حزْمها الشفقة؛ لذا فاليتيم حين يَفقِد أحدَ هذين الموردين المهمين في حياته فإن دواعي ظُلْمه ومَقْته والجفاف معه ستزيد، وخاصة في المجتمعات التي جفَّت ضمائرها، واضمحلَّ الإيمان في مُهَجِها، وقد اختلف العلماء مَن هو اليتيم؟ هل هو مَن فقد أباه أو أمه، والحق أن اليتيم مَن فقَد أحدهما أو كلاهما، بل حتى اللقيط في الجملة فهو أحد الأيتام. قال ابن سعدي: لا تُسئ معاملةَ اليتيم، ولا تُضيِّق صدرَك عليه، ولا تنهره، بل أَكْرِمه، وأعطه ما تيسَّر، واصنع به كما تحب أن يُصنَع بولدك من بعدك[13]، وقالوا: قَهْر اليتيم: أخْذ ماله وظُلْمه، وقيل: هو بمعنى عبوسة الوجه، والمعنى أعم، كما قال - صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: ((اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَن ومن العَجِز والكسل، ومن الجُبْن والبخل، ومن غَلبة الدين وقَهْر الرجال))، فالقهر أعم من ذلك، وخصَّ اليتيم؛ لأنه لا ناصر له غير الله تعالى، فغلَّظ في أمره، بتغليظ العقوبة على ظالمه[14].
ولا أنسَ ذلكم المشهدَ الذي لا زال عالقًا في ذهني دون أن تذهب تفاصيلُه وجزئياته، مشهد تخلَّى عن الإنسانية والرحمة والإسلام، صليتُ ذات يومٍ في مسجد في أحد الأحياء المجاورة لمنزلي قبيل رمضان بيوم أو يومين، وحين فرغتُ من الصلاة وهممتُ بالخروج، رأيتُ طفلاً ذا خمس أو أربع سنوات يترجَّى الناس عند باب المسجد يقول: "أين إمام المسجد؟ أمي تريد أن تُكلِّمه!"، وهكذا ظل عائمًا حتى مرَّ به إمام المسجد والمشهد أمام ناظِري وترجَّاه الطفل أن يُكلِّم أمه عند مصلى النساء، ولكن الإمام ارتَبَك واعتذر، ولي به معرفة سابقة، حينها تردَّدت أنظار الطفل وهي مليئة بالإحباط تارة وبالحزن تارة، وبالبكاء تارة، وبالحسرة تارة، فقد فرغ المسجد من الناس، ولم يَعُد فيه أحد سوى الإمام الذي كان آخر الخارجين وكاتب المقال، حينها توجَّه الطفل تلقائي آيسًا من المساعدة، فوقعت عينا الإمام في عيني، ثم أشار لي بأنه لا يستطيع مساعدته، وفوَّض أمر الطفل لي، حينها رمى الطفلُ بتلك الكلمة لي، لعله أن يؤدي ما عليه! فقال: أمي تريد أن تُكلِّمك)، قلت: وأين هي؟ قال: وراء المسجد عند مصلى النساء، حينها ترجَّلت من الخور، وانطلقت معه حتى فوجئت بامرأة متحجِّبة معها رضيع وفتاة صغيرة دون العشر سنوات، وأخرى كبيرة محجَّبة، فظننتُهم في البداية يرُيدون عرْض مسائل لهم أو شكوى أو غير ذلك، وإذ بي أتفاجأ من المرأة (أمهم) تقول: يا شيخ معي أطفالي أيتام، وها أنت ترانا في حاجة إذا جاءك أرز أو حب أو بُر أو أجهزة كهربائية أو بطانيات فأعطِنا منها، حينها صُعِقتُ حيث أشكال الأطفال لا تَنُم عن فقر وعِوَز، سوى أنه لا عائل لهم، وتلك الفترة كنتُ مديرًا لمركز بناء الأيتام التربوي بذات المحافظة، وأعلم جيدًا أن جمعية رعاية الأيتام (آباء) لن تدَّخِر جهدًا في تقديم المساعدة للمسجلين بها، فبادرتها عاجلاً قلت: لمَ لمْ تذهبي للجمعية، وأنا سأوصلكم لها، وأبشري فيما طلبتِ؟ فتعذَّرتْ وحاولت التعذر بأعذار لم أفهمها، قلت: الجمعية أفضل لكم، ولها برامج ومشاريع تَهتمُّ بالأيتام وبالأسر التي لا عائل لها، حينها تَمتمتْ بكلمات أرادت أن تُخرِجها وأجهشت بالبكاء، ثم حبستْ أنفاسَها لحظات، تريد خفضَ صوتها، وبدأ أبناؤها يلحظونها بأبصارهم، ويحاولون أن يُلملِموا الموقفَ، ولكني صمَّمت على أن تُبدي لي ما لديها، فقالت: سأخبرك، ولكن... قلت: لكن ماذا؟ قالت: لكني خائفة، قلت: لا تخافي إلا من ربك، هاتي ما لديكِ، قالت: أنا وأبنائي لدينا والله الملايين ولكنها حبيسة البنوك!! هل تعرف فلانًا؟ (أحد تجار المحافظة الكبار مات تلك الفترة قبيل لقائي بالمرأة بأشهر)، قلت: نعم، أعرفه - رحمه الله - قالت: أنا أرملته وهؤلاء أبناؤه!! حينها دُهِشت، واستحلفتها بالله هل تَصدُقين؟ قالت: نعم، وقد أخذ المال وحجَر عليه ابنه الأكبر، ومنَع ولايتي على أبنائي، ورفعت أمره للمحكمة والجهات الحكومية وبعض أهله، ولكن هذا لم يُفِد، وقد حرَمنا من مال زوجي حتى اللحظة، ونحن منذ أشهر لم نجد والله مصاريف الطعام والشراب، ولا حتى مصاريف رمضان، انتهت القصة، هذا المشهد يتكرَّر يومًا بعد يوم، وأُجزِم أنه بدأ يُشكِّل ظاهرة، وحسب عملي مع أحبابنا الأيتام، ظهرت لي مواطنُ الظُّلم والعَبَث في أموالهم، واستغلال غياب عائلهم وضَعْف أمهم إن كان الأب المتوفَّى، أو استغلال غياب أمهم من زوج أبيهم أو أقربائهم، وهذا في حق الأقربين آكد، وكذلك الأمر لسائر أفراد المجتمع والجميع مخاطب بهذه الآية {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} [الضحى: 9]، ولذلك كان عليك ألا تقهر اليتيمَ وتَستذِله، بل ارفع من شأنه بالأدب، وهذِّب نفسَه بمكارم الأخلاق؛ ليكون عضوًا نافعًا في جماعتك، ومَن ذاق مرارة اليتم والضيق في نفسه، فما أجدره بأن يَستشعِرها في غيره! وتأمَّل معي تلك النصوص الكثيرة والعظيمة في الحث على العناية باليتيم والقيام عليه والرأفة به، وقد ذكَر الله لفظَ اليتيم في القرآن الكريم ثلاثًا وعشرين مرة، وفي ذلك إشارة واضحة للمسلمين للانتباه والوقوف وقفة جادة أمام هذه الفئة وأمام احتياجاتها، والمشاكل التي قد تُواجِهها سواءً أكانت معنوية أم مادية أم اجتماعية أم غير ذلك، وبالنظر في نصوص القرآن العديدة في شأن اليتيم، فإنه يمكن تصنيفها إلى خمسة أقسام رئيسة، تدور حول: دفْع المضار عنه، وجلْب المصالح له في ماله، وفي نفسه، وفي الحالة الزواجية، والحث على الإحسان إليه ومراعاة الجانب النفسي لديه، تأمَّل معي النصوص القادمة:
1- قال الله: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} [النساء: 36].
2- وقال - عز وجل -: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220]؛ أي: تُعامِلونهم كما تُعامِلون الإخوان، وهذا أعلى درجات الإحسان والمعروف؛ ولذا قال تعالى {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220]، وفي تقديم ذِكْر المُفسِد على المُصلِح: إشعار لشدة التحذير من الإفساد في معاملتِه؛ ولأنه مَحل التحذير في موطن آخر جعلهم بمنزلة الأولاد في قوله: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]؛ أي: حتى في مخاطبتهم إياهم؛ لأنهم بمنزلة أولادهم، بل ربما كان لهم أولاد فيما بعد أيتامٌ من بعدهم، فكما يخشون على أولادهم إذا صاروا أيتامًا من بعدهم، فليُحسِنوا معاملة الأيتام في أيديهم، وهذه غاية درجات العناية والرعاية، تلك هي نصوص القرآن في حُسْن معاملة اليتيم وعدم الإساءة إليه، مما يُفصِّل مُجمَل قوله: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} [الضحى: 9]، لا بكلمة غير سديدة، ولا بحرمانه من شيء يحتاجه، ولا بإتلاف ماله، ولا بالتحايل على أكلِه وإضاعته، ولا بشيء بالكليَّة، لا في نفسه ولا في ماله[15].
3- وقد جعل الله تعالى الإحسان إلى اليتامى قُرْبة من أعظم القربات ونوعًا عظيمًا من البِر، فقال: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177].
4- أهوال القيامة العظيمة وكُرباتها الشديدة، وقد جعل الله لكافل اليتيم منها نجاةً ومخرجًا؛ قال - سبحانه -: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ} [البلد: 11 - 15].
5- أوصى الله تعالى بالإحسان إلى اليتيم الذي ترَك له والدُه مالاً برعاية هذا المال وتنميته وتثميره، وعدم الاعتداء عليه بأي صورة من الصور، فقال: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152]، وقال: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولًا} [الإسراء: 34].
6- ولا يمنع هذا وليَّ اليتيم إن كان فقيرًا أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف؛ لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: 6]، وهذا التجويز لمصلحة اليتيم فلا يطمع الوليُّ في ماله.
7- قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} [الإنسان: 8 - 12]، قال القرطبي: أي يُطعِمون الطعامَ على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له، وكان الربيع بن خثيم إذا جاءه السائل قال: أَطعِموه سكرًا، فإن الربيعَ يُحب السكر، وروى منصور عن الحسن أن يتيمًا كان يَحضُر طعامَ ابن عمر، فدعا ذات يوم بطعامه، وطلب اليتيم فلم يجده، وجاءه بعد ما فرغ ابن عمر من طعامه فلم يجد الطعام، فدعا له بسويق وعسل فقال: دونك هذا، فوالله ما غبَنتَ[16].
8- قال تعالى: {كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ} [الفجر: 17]، يقول سيد: وقد كان الإسلام يُواجِه في مكة حالة من التكالب على جمْع المال بكافة الطرق، تُورِث القلوبَ كزازة وقساوة، وكان ضعف اليتامى مغريًا بانتهاب أموالهم وبخاصة الإناث منهم في صور شتى، وبخاصة فيما يتعلَّق بالميراث، كما كان حب المال وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع المكي قبل الإسلام، وهي سمة الجاهليات في كل زمان ومكان حتى الآن، وفي هذه الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم، تنديدٌ بهذا الواقع، وردْع عنه، يتمثَّل في تَكرار كلمة (كلا).
9- ولقد تنزَّلت في حقِّ اليتيم الآيات في أوائل ما تَنزَّل من القرآن المكي؛ كقوله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الماعون: 1 - 3]، ومفهوم الآيتين المباركتين، أن الذي يَطرُد اليتيم، ويَحرِم اليتيمَ حقَّه، هذا هو الذي يُكذِّب بالدِّين؛ تعبيرًا عن الترابط العميق بين الدين، وبين الاهتمام بشؤون الأيتام، وبين الإيمان وبين الاهتمام بشؤون المُتعَبين، فلا يمكن أن يبقى الإنسان متدينًا ويَطرُد اليتيمَ.
10- أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد بلغ من عنايته باليتيم أن بشَّر كافليه بأنهم رفقاؤه في جنة عرْضها السموات والأرض حين قال: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا))، وأشار بالسبابة والوسطى وفرَّج بينهما شيئًا، وقد قال ابن بطَّال: حُقَّ على مَن سمِع هذا الحديثَ أن يعمل به؛ ليكون رفيقَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنة، ولا منزلة أفضل من ذلك.
11- كما بشَّر النبيُّ مَن أَحسَن إلى اليتيم، ولو بمسح رأسه ابتغاء وجه الله بأجر كبير؛ حين قال: ((مَن مسَح رأسَ يتيمٍ، لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة مرَّت عليها يده حسنات، ومَن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين)).
12- وعدَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكلَ مالِ اليتيم من السبع الموبِقات؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اجتنِبوا السَّبعَ الموبقات))، قالوا: يا رسول الله، وما هنَّ؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتْل النَّفْس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذْف المحصنات المؤمنات الغافلات))[17].
المفهوم الصحيح للكفالة:
قال - عليه الصلاة والسلام -: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرَّج بينهما))[18]، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: أتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجل يشكو قسوةَ قلبه فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أتحب أن يَلين قلبك وتُدرِك حاجتَك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسَه وأطعمه من طعامك، يَلِن قلبُك وتُدرِك حاجتك))[19]، وقد يظن كثيرٌ من الناس أن كفالة اليتيم تعني فقط النَّفقة عليه، وهذا لا شك فَهْم قاصر بالرغم من عِظَم ثواب النفقة في ذاتها إلا أن مفهوم الكفالة أوسع من ذلك، قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم[20]، وليس من باب الإساءة إلى اليتيم تأديبه والحزم معه وتعويده على معالي الأمور ومكارم الأخلاق ولو اضطر أحيانًا للشدة، بل ذلك من مصلحته كما قيل:
فقسا ليَزدجِروا ومن يك حازمًا = فليَقسُ أحيانًا على مَن يَرحم
يقول ابن عابدين - رحمه الله -: "وله ضرب اليتيم فيما يَضرِب ولده"[21]. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "يجوز ضرب اليتيم لتأديبه بغير إلحاق ضررٍ به أو أذى أو إذلال"[22]؛ انتهى.
5- {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [الضحى: 10]: هنا السائل لم تُحدَّد هُويَّتُه ولا جنسه ولا مسألته، بل أي سائل سواء سأل الطعام أو المال أو العِلم أو الخدمة، لا تنهره ولا تَزجُره، قال ابن سعدي: "وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم"[23]، "واليتيم والسائل منصوبان بالفعل الذي بعده، وحقُّ المنصوب أن يكون بعد الفاء، والتقدير: مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم، ولا تنهر السائل"[24]، وقد يُقعِد الشيطانُ البعضَ بحيل لا تقف، فقد يُوهِم المُنفِق بكذب السائل أو تزويره للحقائق، وهذا يظهر للبعض مع القرائن - إن وُجِدت - لكن من لم يظهر له شيء فليتمعَّن في هذا الحديث العظيم؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قال رجل: لأتصدَّقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضَعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدَّثون، تُصُدِّق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدَّقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدَّثون تُصُدِّق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدَّقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدَّثون تُصُدِّق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صَدقتُك على سارق، فلعله أن يَستعِفَّ عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تَستعِفَّ عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فيُنفِق مما أعطاه الله))؛ رواه البخاري (1355)، فأعطِ السائل وأَحسِن النية، فإن لم تُعْطِه، فالجواب بلطف قد يقوم مقامَ العطاء، وكما قيل: فليُسعِد النُّطق إن لم يُسعِد المال، وتأمَّل معي في حديث الأعرابي عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه بُرْد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه الأعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرتُ إلى صفحة عاتِقِ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أثَّرتْ بها حاشية الرداء من شدة جبْذته، ثم قال: يا محمد! مُرْ لي من مال الله الذي عندك، وهذه الرواية في الصحيحين، وفي رواية أخرى: "لا من مال أبيك، قال: فالتفت إليه، فضَحِك - صلى الله عليه وسلم - ثم أمر له بعطاء"، ورُوي عن النبي مرسلاً عن زيد بن أسلم - رضي الله عنه -: ((أَعْطُوا السَّائل وإن جاء على فَرَسٍ))[25]، قال ابن عبدالبر - رحمه الله -: "لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافًا بين رواة مالك، وليس في هذا اللفظ مُسنَد يُحتَج به فيما علِمتُ"[26].
وروي في الأثر: "لا يَمنعنَّ أحدُكم السائلَ، وأن يُعطيه إذا سأل، ولو رأى في يده قُلبين من ذهب"[27]، والقُلب: هو السوار، وقد حُكي أن عمر بن عبدالعزيز بعث مالاً يُفرَّق بالرقة، فقال له الذي بعث معه: يا أمير المؤمنين، تبعثني إلى قوم لا أعرفهم، وفيهم غني وفقير، فقال: كل مَن مدَّ يده إليك فأعطِه [28]، قال ابن عثيمين: لكن هذا العموم يَدخُله التخصيص؛ إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يُريد التعنُّتَ، وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان، حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فإذا علِمتَ ذلك فهنا لك الحق أن تنهره، وأن تقول: يا فلان، اتقِ الله، ألم تسأل فلانًا كيف تسألني بعدما سألته؟! أتلعب بدين الله؟! أتريد إن أفتاك الناسُ بما تحب سكتَّ، وإن أفتوك بما لا تحب ذهبتَ تسأل؟! هذا لا بأس؛ لأن هذا النهر تأديب له، وكذلك سائل المال إذا علِمتَ أن الذي سألك المال غنيٌّ فلك الحق أن تَنهَره، ولك الحق أيضًا أن تُوبِّخه على سؤاله وهو غني، إذًا هذا العموم "السائل فلا تنهر"، مخصوص فيما إذا اقتضت المصلحة أن يُنهَر فلا بأس[29].
إن جملة السائلين في مرتبةٍ أدنى من المسؤول؛ ولذا كان النهي صريحًا عن نهرهم، حتى لا تتطبَّع النفوس على مقْت الأدنين، فهي ثُلْمة في الإيمان، وشرخ في المجتمع، والله أعلم.
6- {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: 11]؛ النعمة: كلُّ ما أنعم الله به على العبد، من: مال، وعافية، وهداية، وقيل: المراد بها: "المذكورات والتحدث بها شكْرُها عمليًّا من إيواء اليتيم كما آواه الله، وإعطاء السائل كما أغناه الله، وتعليم المسترشد كما علَّمه الله، وهذا مِن شُكْر النِّعمة، أي: كما أنعم الله عليك، فتُنعِم أنت على غيرك؛ تأسيًا بفعل الله معك"[30]، وحقيقة الشكر ظهور أثر النِّعَم الإلهيَّة على العبد في قلبه إيمانًا وفي لسانه حمدًا وثناءً وفي جوارحه عبادة وطاعة، إن شُكْر النِّعم مظنَّة بقائها، ومن تَعاظَم شُكْرَ الله محق الله ما لديه، وهذا لعمري من ضَعْف الإيمان وقلة البصيرة أن يَهبَك الله النعمة، ثم تَنقلِب جاحدًا {إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ} [العاديات: 6]، والكنود: هو الذي لا يشكر نِعمَه، قال الحسن: أي يَعُد المصائبَ وينسى النِّعمَ[31]، والتحدث بالنِّعم شكْرٌ وترْكها كفر، ومَن لا يشكر القليلَ، لا يشكر الكثير ومَن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن فضائل الشكر أن قَرَنه الله بالإيمان، وأنه لا غرَض له في عذاب الخَلْق، إذا قالوا آمنا {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا} [النساء: 147]، وقسَّم الله تعالى الناسَ إلى شكور وكَفور فأبغض الأشياء إليه الكُفْر وأهل الكفر، وأَحَبُّ الأشياء إليه الشكر وأهل الشكر، {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} [الإنسان: 3]، ووعد - جلَّ في علاه - الشاكرين بالزيادة: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم: 7]، وعلَّق الله المزيد بالشكر والمزيد من لا نهاية له، كما أن الشكر لا نهاية له.
وأخبر - سبحانه وتعالى - أن إبليس من مقاصده أن يمنع العبادَ من الشكر، فتعهَّد إبليس بأشياء: {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} [الأعراف: 17]، فإبليس يريد حرمانَهم من الشكر والقعود بينهم وبينه، ووصَف الله الشاكرين بأنهم قليل من عباده؛ {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13].
عبد الله، أَظهِر ما منَّ الله عليك من نعمة من غير تكلُّف ولا حماقة، اشكُرِ الله على نِعَمه بإظهار نعمه عليك، وبالحديث عنها وتعديدها، واستعملها في طاعته - تبارك وتعالى - وحُثَّ الناس على الشكر الذي يُبقي النِّعمَ ويزيدها {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7]، وحَذِّرهم من البَطَر والكفر: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [النحل: 112].
وإن من دعائم الشكر ووسائله أن تنظر إلى مَن هو دونك، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((انظروا إلى مَن هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى مَن هو فوقكم؛ فإنه أجدر ألا تَزدروا نِعمة الله))[32]، فمما يحفظ العبد من ترْك الشُّكر عندما ينظر إلى مَن هو فوقه أن هذه يُقرِّر في نفسه أنها قِسْمة الله: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 165]، ومن الوسائل أن ندعو الله أن يُعيننا على الشكر: ((اللهم أعنِّي على ذِكْرك وشُكْرك وحُسْن عبادتك))[33]، وما أجمل أن يتَّخِذ المرء مَن يُعينه على الشكر ويُذكِّره إياه؛ فقد سُئل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أي المال نتَّخِذ؟ فلفت نظرَهم - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ليتَّخِذ أحدكم قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجة مؤمنة تُعين أحدكم على أمر دِينه ودنياه))[34]، ومَن وسائل الشكر أن تُرَ النعمةُ عليك؛ فعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيتُ رسولَ الله وأنا قَشِف الهيئة، فقال هل لك من مال؟ قلت: نعم، قال: من أي المال؟ قلتُ من كل المال، الإبل، الرقيق، النعم، الخيل.. قال: ((إذا آتاك الله مالاً فليُرَ عليك))[35]، والشكر مع المعافاة عند بعض أهل العِلم أعظم من الصبر على الابتلاء، قال مطرف بن عبدالله: "لأن أعافى فأشكُر أحبُّ إلي مَن أن أبتلى فأصبر"[36]، وتذكَّر أن بالشكر تُحفَظ النِّعم، وتدوم المنح، قال عمر بن عبدالعزيز: "قيِّدوا نِعمَ الله بشكر الله"[37]، قال أبو بكر الجزائري: ومن هداية الآيات: تقرير معنى الحديث: "إذا أنعم الله تعالى على عبده نعمةً أحبَّ أن يرى أثرَها عليه"[38]. وعن أبي نضرة: قال: "كان المسلمون يرون أن من شُكْر النِّعم أن يُحدَّث بها"[39]، لكن تَحدَّث بها إظهارًا للنعمة وشكرًا للمنعم، لا افتخارًا بها على الخَلْق؛ لأنك إذا فعلتَ ذلك افتخارًا على الخَلْق، كان هذا مذمومًا، أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدُّثًا بالنِّعم، وشكرًا للمنعم، فهذا مما أمر الله به[40]، واحترس من كسْر نفوس الفقراء، وأن تتحدَّث بنعمك عند حاسديها.
لطيفة: وقف الله الكثيرَ من الجزاء على المشيئة {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 28]، وفي الإجابة: {فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ} [الأنعام: 41]، وفي المغفرة: {يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} [الفتح: 14]، وفي الرزق: {اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ} [الشورى: 19]، وفي التوبة: {وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ} [التوبة: 15]، أما الشكر فإنه أَطلَقه: {وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144]، {وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 145]، ولم يقل: "إن شاء"!
وفي نهاية المطاف نُعقِّب بكلام موجَز لسيد قطب - رحمه الله -: وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهْره وكسْر خاطره وإذلاله، وإلى إغناء السائل مع الرِّفق به والكرامة، كانت كما ذكرنا مرارًا من أهم إيحاءات الواقع في البيئة الجاحدة المتكالِبة، التي لا ترعى حقَّ ضعيف، غير قادر على حماية حقه بسيفه! حيث رفع الإسلام هذه البيئة بشرعة الله إلى الحق والعدل، والتحرج والتقوى، والوقوف عند حدود الله، الذي يَحرُس حدودَه ويَغار عليها ويَغضَب للاعتداء على حقوق عباده الضِّعاف الذين لا يَملِكون قوة ولا سيفًا يَذودون به عن هذه الحقوق[41].
وختامًا نَحمَد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، ونسأل الله أن يُوفِّقنا لهداه ونعوذ به من عِلْم لا ينفع، ومن نفْس لا تَشبَع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تُسمَع، وصلى الله وسلم على محمد.