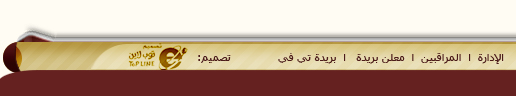وهم فئة من أهل نجد قاموا في الفترة الواقعة بين عام : 1164/1750م وعام :1370هـ/1950م بربط التجارة بين الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر ودول المغرب العربي والهند وكانوا يطلبون الرزق ويجلبون الخير إلى البلدان التي كانوا يرتادونها، كذلك شاركوا بالأعمال الحربية في تلك الدول والدفاع عن الدول العربية في الشام ومصر والعراق لغرض إعلاء كلمة التوحيد والدفاع عن إخوانهم المسلمين في تلك البقاع، يحدوهم في ذلك الإيمان الصادق بالله بلا رياء ولاسمعة. حيث قال فيهم الشاعر:ـ
أولاد علي لابتي مالها أجناس بشّاشة بضيوفهم والمسايير
ان عدوا الأجواد هم ذروة الناس وهم هل الطولات زين المقاصير
أما سبب تسميتهم بالعقيلات فقد روي في ذلك عدة أقوال منها: أنهم سموا بذلك نسبة للعقال الذي كانوا يلفّونه على رؤوسهم وهي علامة دالة عليهم وتميزهم عن الأتراك وأهل الشام ومصر والعراق . وقيل أنهم سموا بذلك بسبب أنهم كانوا يعقلون الإبل والخيل أي يضعون العقال في أقدام إبلهم وخيولهم عندما يصدرون من أعمالهم. وقيل بأنهم سموا بذلك من العقل حيث كانوا يحكّمون عقولهم في جميع أمورهم التجارية والعسكرية وهذا جعل منهم مجموعة تتميز بالحكمة والروية في معالجة الأمور وحسن التصرّف عندما تضيق بهم الحياة.
وكانت الزبير التي تقع في غربي البصرة أول منافذ العقيلات إلى الخارج والتي هي بوابة نجد إلى الخارج وطريق القوافل من نجد إلى الأحساء ثم الشام وكان لتشابه جوّها وتربتها وطبيعة السكن فيها مع ديار العقيلات في نجد أثر هام في تهيئة الإستقرار لهم فيها، كذلك وجود الزراعة والكلأ لرعاية الأغنام والإبل جعل المال يكثر عندهم وتزداد التجارة ويعمّ الترف والنعيم بينهم من الحليّ والثياب الجميلة والنعمة الظاهرة عليهم.
وكانت الدولة العثمانية ترحب برجال العقيلات لوجود مايميزهم عن غيرهم كالشجاعة والإقدام والكدح في طلب الرزق، كما كانوا يدافعون عن البلاد التي يسكنونها. كما كانت الدولة العثمانية تستعين بهم في الدفاع عن الديار وتعينهم جنود محليين بل كانوا العمود الفقري لجنودها تستشيرهم في أعمال الحروب وتأخذ برأيهم في كل نائبة، كذلك كان رجال العقيلات الذين في الشام هم روّاد التجارة واستمروا يحملونها ويسوّقونها سنوات طويلة. وكانوا يشترون الإبل والأغنام والأنواع الأخرى من الماشية من شمر والعمارات والحجاز إلى الشام ويبيعونها. كذلك كان رجال العقيلات العاملون لدى الأشراف بالمدينة المنورة وماحولها يستعين بهم الأتراك في حروب الشام أمثال ابن دغيثر وابن دخيل وغيرهم.
يقول فيهم عبدالله بن زايد الطويان (رجال في الذاكرة)(1) (ذلك أن العقيلات رحمهم الله جميعا كانوا مدارس متنقلة بالإضافة إلى تجارتهم كانوا جيوشا يدافعون عن مصالح الأوطان، وكانوا أهل فضل وريادة في العطاء للبلاد التي يمرون عليها أو يقيمون على أرضها).
كما كانوا يساهمون بكل الأنشطة التجارية والعمرانية والعسكرية والإجتماعية في البلدان التي يقيمون فيها.
من تلك الأنشطة: مدينة (الخميسية) بالعراق التي أنشأها عبدالله بن صالح الخميس عام 1307هـ وكان أميرا عليها. كذلك إنشاء صوب عقيل في بغداد الذي كان ينبض بالنشاط. كذلك أنشأوا جامع الخنيني بالعراق الذي يعتبر معلما من معالمها وصرحا يؤدي رسالته الإسلامية ومكانا لاجتماع المسلمين يؤدون فيه مشاعرهم ويحلون فيه مشاكلهم ويتواصلون فيه. ولاننسى أوقاف الروّاف في بغداد التي لها الأثر الواضح في تطوير مدينة الزبير ومدينة البصرة. وسوق الشيوخ الذي يغص بالحركة التجارية. وكذلك الميدان الواسع في الشام الذي كان لهم دور فيه. ومن أنشطة العقيلات المشاركة في حفر قناة السويس وكان لهم دور هام في حفز همم الرجال ووبث الحماس فيهم لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سوف يعود بالنفع والفائدة لدولة مصر.
أما الأنشطة الثقافية للعقيلات في الخارج فهو إنشاء صحيفة (الرياض) المشهورة في بغداد التي أنشأها ويقوم عليها سليمان الدخيل عام 1910م. كذلك أصدر مجلة (الحياة) في بغداد والتي كانت منبرا إعلاميا هاما في تلك الناحية.
أما في المجال العسكري: فقد كان العقيلات يشاركون إخوانهم العرب والمسلمين في حروبهم وفي صد العدوان عنهم ويدافعون عن ديار أخوانهم المسلمين، مثل معركة ميسلون التي قادها البطل ناصر بن دغيثر بالشام ضد الفرنسيين الذين جاءوا لاحتلال سوريا وأبلوا فيها بلاء حسنا وكانت لهم فيها بطولات أشاد بها المواطنون السوريون. كما اشترك العقيلات في الحروب التي دارت رحاها في فلسطين بجانب إخوانهم هناك. كذلك شاركوا في توحيد البلاد السعودية مع الملك عبدالعزيز أثناء جولاته لتوحيد المملكة.
والعقيلات يملكون اصطبلات ومرابط للخيول خاصة بهم في البلدان التي يرتادونها مثل العراق والشام ومصر. ولهم مشاركات في سباق مضمار الخيول في مصر عام 1320هـ وبرز منهم مجموعة من الخيّالة والمدربون المهرة مثل: عبدالله أبا الخيل، وصعب التويجري، وعبدالرحمن العجلان، وعبدالعزيز السابق، وحمود المطلق.
وللعقيلات مجموعة من الأمراء اشتهروا بينهم بالفضل والصلاح والحكمة والكرم يتوزعون في البلدان التي يذهبون إليها وهؤلاء الأمراء عادة تكون بيوتهم مفتوحة للجميع من العقيلات، ومنهم: محمد بن عبدالله البسام، محمد بن أحمد الرواف، ابراهيم بن سليمان الجربوع، ابراهيم بن علي الرشودي، حمود بن عبدالله البرّاك، صالح بن سليمان المطوّع، ابراهيم بن عبدالرحمن الشريدة، عيسى بن رميح الرميح، فوزان بن سابق الفوران، محمد بن علي الشويهي، مسلم بن ابراهيم الفرج، ناصر بن عبدالله الصبيحي، حمود بن عبدالله النجيدي، عبدالله بن صالح المديفر. ويذكر الطويان بأن هؤلاء من سادة العقيلات.
كذلك كان منهم قادة عسكريون مثل: ناصر بن علي الدغيثر،عبدالله المكيرش، فهد بن عبدالله الوهيبي، فهد الشارخ، محمد بن رشيد البلاّع، ناصر الروّاف، عبدالله بن عيسى، مبارك الدغيثر، منصور الشعيبي، محمد ابن عقيّل، سعد السكيتي، صالح بن جليدان، ناصر بن حمود، محمد بن صالح المرشود.
وقد ألف الأستاذ ابراهيم المسلم كتابا كاملا عن العقيلات. كما تحدث عنهم الباحث محمد بن ناصر العبودي في كتابه الأمثال العامية في نجد. والدكتور حسن الهويمل تحدث عنهم بإسهاب في كتابه عن بريدة.
لماذا سكت الخريجي عن العقيلات؟
د.عبدالعزيز جارالله الجارالله
* دعونا نتفق هل (العقيلات) تجار أم مهاجرون!! هل هم مثل القوميات والأقليات التي هاجرت خارج أوطانها واستوطنت أم أنهم تجار تتحكم بهم ظروف تجارتهم يرحلون من أرض نجد والقصيم متبضعين تقودهم تجارتهم.. وما المدن الشامية والمصرية والعراقية إلاّ محطات ونقاط توزيع لهؤلاء التجار!! بهذا الصورة تمنيت على الأستاذ منصور بن محمد الخريجي نائب رئيس المراسم أن يكون حديثه عن العقيلات وبهذه الصورة أيضاً تمنيت أن يكون الحوار الذي أجراه الزميل الأستاذ محمد رضا نصر الله مع ضيفه منصور الخريجي في برنامجه مساء يوم الجمعة الماضي (هذا هو) في محطة m.b.c.. لكن الحوار مر على تاريخ العقيلات كحلم مسائي عابر.
الأستاذ منصور الخريجي من الشخصيات القادرة على الحديث عن العقيلات في تاريخها المتأخر أو في آخر فقرات عقيل قبل أن تتوقف.. فلدى منصور الخريجي الوعي السياسي والرؤيا التاريخية والبعد الاجتماعي الذي يمكنه من تشخيص تلك الحقبة التاريخية.. لديه الثقافة الشعبية والفكر السياسي الذي يمكنه من تقديم تفسيرات تاريخية وفلسفية لهؤلاء التجار الذين أفرزت حقبتهم ارهاصات ساهمت في تشكيل البنية الاجتماعية والثقافية لمجتمع وسط الجزيرة الذي كان معزولاً عن العالم على أقل تقدير أوائل القرن العاشر وما تلا ذلك من قرون.
كنا ننتظر من العقيلي الأستاذ منصور الخريجي وهو آخر العقيليين أن يتحدث عن تجربته وعن خط سير حركة عقيل مما يختزنه في ذاكرته ويقدم صورة تشخيصية للتركيبة التجارية والسكانية لمجتمع عقيل.. رغبنا بالعمق التحليلي متجاوزين عبارة التسمية انهاجاءت من (عقال الجمل) أو لبس العقال وهو يدرك جيداً أن عقيل بقايا رحلات عريقة عرفتها الجزيرة العربية تعود إلى فترة ما يعرف بالزمن الجاهلي أو فترة الممالك العربية القديمة وأن عقيلات القرن الثالث عشر والرابع عشر هم امتداد لأمة وكيانات سياسية وتجمع لقبائل بني عقيل الذين بدأ تاريخهم قبل الإسلام حين كانوا يستوطنون غرب القصيم وتنقلوا عبر أرجاء الجزيرة العربية وأسسوا دويلات في وسط وشرق الجزيرة وانتشروا كأمة وكيانات سياسية في سوريا والعراق وشمال أفريقيا والأندلس وأسسوا في سوريا والعراق دويلات عاشت في فترات متقطعة من القرن الثالث حتى أواخر القرن العاشر الهجري وجعلوا من طرق ودروب الحج والتجارة في الجزيرة العربية مساراً لهم ولتجارتهم حيث سلكوا درب زبيدة الشهير وطريق البصرة وطريق الحج الشامي المصري التي تربط مكة المكرمة والمدينة المنورة بشرق العالم الإسلامي وبلاد الرافدين الشام والعراق وشمال أفريقيا هذا الإطار التاريخي هو البعد الزمني والثقافي الذي تمنيت من الأستاذ منصور الخريجي أن يقدمه للمشاهد وليست الصورة التي تم طرحها أنهم مهاجرون غادروا أرض الجزيرة تحت ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة هرباً من الفقر وشح البيئة والعودة لها ثانية بعد أن استقرت الأمور وعم الرخاء ودخلت المملكة بالنماء الاقتصادي.. هذه الصورة النفعية هي ظلم لهؤلاء التجار الأوائل الذين جعلوا من أنفسهم بوابة ومصدراً اقتصادياً وموارد معيشة لأهلهم بالداخل حين كانت منطقة نجد تعيش على اقتصادها المحلي المحدود الفقير في موارده.
العقيليون ـ العقيلات ـ يحتاجون إلى إعادة كتابة من منظور تاريخي وسياسي واجتماعي واقتصادي فلهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في صمود تلك الواحات والخبوب والقرى النجدية الفقيرة واستمرارها في ظرف تاريخي صعب ومرحلة حضارية معقدة.. فالعقيلات كانت أحد الموارد الاقتصادية وقفت في وجه الرمال والغزاة من أن تبتلع أهل القرى المسالمين..
أكرر أن الأستاذ منصور الخريجي مع آخرين قادرون على كتابة تاريخ عقيل.
منقولة من جربدة الرياض